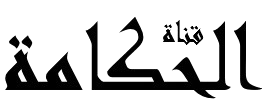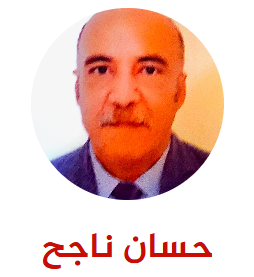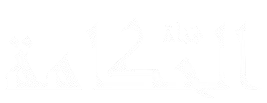–الجزءالأول–
مدخل عام: السياق والإطار العام لمشروع الإصلاح
عرف المغرب خلال العقد الأخير دينامية إصلاحية واسعة للإدارة العمومية، شملت مراجعة نظام الوظيفة العمومية، تبسيط المساطر عبر القانون 55.19، وتعزيز النزاهة بموجب القانون 46.19. كما تم إطلاق مشاريع رقمية لتقريب الخدمات من المواطن.
ضمن هذا السياق، برزت أهمية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) التي تكتسي طابعا استراتيجيا متميزا يجعلها بمثابة فاعل أساسي في دينامية المشاريع الاستثمارية. مما يقتضي ضرورة تمكين هذه المؤسسات من الآليات والوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها المتقدم كمحفز و راصد للاستثمارات، إلى جانب وظيفتها التقليدية المرتبطة بجودة الإطار المعيشي للمواطن، وبحُسن تنظيم المجال، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع التجهيزات والبنيات التحتية والمرافق العمومية.
ويهدف هذا التغيير إلى تحديث أساليب تدبير المؤسسات العمومية، بما يرفع من فعاليتها. كما يُنتظر منها أن تساهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقريب الخدمات من المواطن.
من وجهة نظر بنيوية، يُعتبر ورش إصلاح المؤسسات العمومية مدخلًا حاسمًا لتنزيل هذه الجهوية بشكل فعال، عبر نقل بعض الاختصاصات المركزية، وتقوية قدرات التدبير المحلي و تطبيق الممارسات الجيدة للحكامة الترابية. ولعل إصدار القانون الإطار رقم 50.21 في يوليوز 2021 يعد محطة مفصلية في هذا المسار باعتباره حجر الزاوية في تأسيس حكامة جديدة قائمة على الأداء، والمساءلة، والتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
يهدف هذا المقال إلى تحليل هذا الورش الإصلاحي من خلال خمسة أبعاد رئيسية، مع التركيز على التحديات والسبل الكفيلة بتحقيق إصلاح فعلي للإدارة العمومية وتعزيز إنتاجيتها.
إشكالية الإصلاح والمنهجية المعتمدة
يعتمد هذا التحليل منهجية متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب التنظيمية، القانونية، المالية، والتقنية، بالإضافة إلى البعد البشري باعتباره محوراً أساسياً في معادلة الإصلاح. وتكمن التحديات في تحقيق توازن بين تحديث الحكامة، ضمان الاستدامة المالية، وتعزيز البعد الاجتماعي والبيئي، وسط تشابك الأبعاد المختلفة.
وتطرح الإصلاحات تحديات معقدة تتعلق بالمركزية، وتفعيل الإطار القانوني، ومقاومة التغيير. انطلاقًا من ذلك، تُطرح الإشكالية المركزية كالتالي: كيف يمكن لإصلاح المؤسسات العمومية أن يوازن بين الحكامة، والاستدامة المالية، والمسؤولية الاجتماعية، في ظل تحديات تنظيمية واقتصادية وقانونية متشابكة؟
بالنظر إلى أهمية فهم السياق المؤسساتي الذي سبق الإصلاح، سنبدأ بتحليل الإطار التنظيمي الذي يمثّل الأساس البنيوي الذي يقوم عليه هذا الورش.
السياق التاريخي ودوافع الإصلاح
يُعد إصلاح المؤسسات العمومية في المغرب ثمرة تشخيص طويل الأمد، انطلق منذ ثمانينيات القرن الماضي، مدفوعاً بتوصيات مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك مؤسسات وطنية مثل المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان ومؤخرا كذلك الهيئات الاستشارية الدستورية. وقد كشفت التقارير عن توسع غير منضبط للمؤسسات العمومية وتداخل في المهام وضعف التنسيق، ما استدعى إصلاحاً شاملاً.
وفي هذا الصدد، فقد كشفت التقارير الصادرة عن الهيئات الدستورية عن انتشار وتوسع غير منضبط للمؤسسات العمومية، التي بلغت 269 مؤسسة سنة 2021، منها 225 مؤسسة عمومية و44 شركة مساهمة، فضلاً عن أكثر من 500 فرع ومساهمة غير مباشرة للدولة. وقد أسفر هذا الانتشار عن تداخل واضح في المهام، وضعف شديد في توزيع المسؤوليات، وتكرار في الأنشطة، مما انعكس سلباً أحيانا على فعالية ونجاعة الإدارة العمومية.
تسعى الإصلاحات الحالية إلى تحسين الحكامة، وتحديث الإطار القانوني، وتعزيز الأداء، عبر مجموعة من المحاور، من أبرزها، تفعيل التعاقد مع الدولة، تقليص الأنشطة غير الأساسية، تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، إصلاح الموارد البشرية، وتطهير الوضع المالي.
الفصل الأول: مقاربة متعددة الأبعاد لمشروع الإصلاح المؤسساتي
البعد التنظيمي: اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية
في سنة 2018، اعتمد المغرب المرسوم 2-17-618 المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري لتعزيز فعالية السياسات العمومية على المستوى الترابي، عبر تفويض بعض الاختصاصات من الإدارات المركزية إلى المصالح الخارجية. يقوم هذا النموذج على مبادئ القرب، الفعالية، والتكامل، ويهدف إلى دعم الجهوية المتقدمة. وقد عزز هذا التوجه إصدار قانون 54.19 حول ميثاق المرافق العمومية، الذي يركز على الشفافية وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
لكن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة تحديات، أبرزها محدودية تفويض الصلاحيات، بطء التنفيذ، ضعف الموارد الجهوية، وتضارب الاختصاصات بين الإدارات اللاممركزة والسلطات المحلية. لذلك، لتحقيق فعالية حقيقية، يجب اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين اللاتمركز واللامركزية، مع وضوح الأدوار والمسؤوليات وتعزيز حكامة ترابية فعّالة.
مزايا اللاتمركز الإداري مقارنةً باللامركزية
يمكن تلخيص مزايا اللاتمركز مقارنة بالمركزية في كونه يُعزّز فعالية تنفيذ السياسات، ويُبقي على وحدة القرار، ويُمكّن من الرقابة الإدارية المباشرة، ويُقرب الخدمات من المواطن. ومع ذلك، لا يمنح اللاتمركز استقلالية حقيقية للمصالح الجهوية، مما يحد من التكيف مع الخصوصيات المحلية ويُبطئ اتخاذ القرار. كما لا يتيح مشاركة فعالة للمواطنين في التدبير، خلافًا للامركزية التي تدعم الديمقراطية المحلية.
لذلك، من الضروري تحقيق تكامل فعلي بين اللاتمركز واللامركزية، مع تكييف هياكل المؤسسات ومنح صلاحيات واضحة للمستويات الجهوية، في إطار حكامة ترابية متوازنة. إلا أن استمرار المركزية والجمود الإداري يعرقلان الفعالية، بينما تثير إصلاحات تحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة تخوفات اجتماعية مرتبطة بفقدان الشغل وتدهور شروط العمل.
رغم إدخال إصلاحات لتعزيز حكامة المؤسسات العمومية، لا تزال هناك اختلالات هيكلية تمس المجالس الإدارية، أبرزها: غياب معايير دقيقة للتعيين، دور شكلي للمجالس، هيمنة الرقابة القبلية، ضعف التنسيق بين القطاعات، قلة الاجتماعات، محدودية الشفافية، وغياب تقييم شامل للأثر الاجتماعي والبيئي.
وقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإصلاحات تمس أربع محاور:
- وضع استراتيجية واضحة لتقليص عدد المؤسسات وتركز الدولة على المهام الاستراتيجية.
- ترشيد العلاقة المالية مع الدولة.
- تقوية الحكامة الداخلية.
- تدبير موحّد للمحفظة العمومية.
كما تستمر الانتقادات بخصوص غياب الشفافية والوضوح في التعيينات، حيث تطغى المصالح السياسية على مبدأ الجدارة، مما يضعف الثقة، ويُقصي الكفاءات، ويُعرقل الإصلاح.
واختيار المغرب للاتمركز كان سعياً للحفاظ على وحدة السياسات العمومية، إلا أن محدودية تفويض الاختصاصات وتضاربها مع السلطات الترابية تُبرز الحاجة لنقاش جديد حول حكامة القطاع العام، خاصة في ظل ضعف تكوين المتصرفين وتحيزات سلوكية داخل أجهزة القرار(Biais Comportementaux).
محفظة الدولة للمؤسسات العمومية: إحصائيات وتحديات
مع نهاية 2024، بلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب 271 وحدة، تشمل قطاعات حيوية كالصحة، التعليم، الإسكان، والطاقة. وقد حققت هذه المؤسسات رقم معاملات بلغ 332 مليار درهم عام 2023، مع مديونية مرتفعة وصلت إلى 326 مليار درهم. كما ساهمت في تمويل الميزانية من خلال عمليات الخوصصة التي درّت 121 مليار درهم منذ 1993، مما يثير نقاشًا حول توازن بين منطق الدولة الاجتماعية والدولة المقاولة. هذا الواقع يُبرز الحاجة إلى إصلاح مالي وهيكلي يعزّز فعالية هذه المؤسسات ويضمن استدامتها وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة، مع تقييم دقيق لسياسة تقليص عددها وأثرها على جودة الخدمات.
البعد القانوني: الإطار القانوني الجديد و دور الدولة
بعد الوقوف على المعطيات التنظيمية التي تؤطر المؤسسات والمقاولات العمومية، تبرز أهمية التطرق إلى الإطار القانوني الذي يشكل الأرضية التشريعية لهذه الإصلاحات.و في هذا المنوال، يشكّل القانون الإطار 50.21 حجر الزاوية في الإصلاح المؤسساتي، إذ يُؤسس لحكامة قائمة على النتائج والقيمة المضافة، ويُعيد تعريف دور الدولة كمساهم استراتيجي من خلال إنشاء “الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الإستراتيجية للدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية” (ANGSPE) لتدبير المساهمات وتتبع الأداء.
كما تم خلال السنة الجارية اعتماد مدونة وطنية للحكامة وفق معايير دولية. ورغم أهمية هذا الإطار القانوني، تعاني عملية التنزيل من ضعف آليات الرقابة، واستمرار ممارسات تقليدية في التعيين والتدبير، ما دفع البرلمان إلى توجيه انتقادات للوكالة بسبب غياب الشفافية، وضعف التنسيق، وتأثير قراراتها سلباً على التوظيف والإنتاجية والاستثمار. ومع ذلك، يبقى هذا الإطار مرجعية أساسية لتعزيز فعالية المؤسسات وضمان استدامة إصلاحها. ومع ذلك، يبقى هذا الإطار القانوني المدخل المحوري لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإصلاح المؤسسات العمومية، عبر ترسيخ دور الدولة كمساهم استراتيجي، بما يضمن تحقيق الفعالية في الأداء.
الأهداف الإستراتيجية للإصلاح
يرتكز المشروع الإصلاحي على محاور إستراتيجية واضحة، يمكن تلخيصها في تحسين ممارسات الحكامة، إذ تهدف الدولة من خلال التغيير إلى تعزيز ثقافة تقييم الأداء بالنتيجة، عبر تأهيل مجالس الإدارة، وضمان الكفاءة في تعيين أعضائها، وتبني علاقة تعاقدية واضحة بين المؤسسات والدولة، مع التركيز على الأهداف المحققة بدلاً من مجرد تقديم الأنشطة المنفذة. كما تسعى إلى التحول القانوني والإداري حيث يقوم هذا المحور على تحويل المؤسسات ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة ذات مجالس إدارة مستقلة، تُدار وفق منطق المقاولة، بهدف زيادة تنافسيتها وتمكينها من استقطاب الاستثمارات الخاصة، محلياً ودولياً.
ويبقى الهدف الأهم الذي يسعى إليه الإصلاح، هو دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحكامة، بحيث يُعد إدراج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة (ESG: Environnement, Social, Gouvernance) في تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب توجهًا استراتيجيًا يعكس تطورًا في الفهم الحديث لدور هذه المؤسسات، الذي لم يعُد محصورًا في تحقيق النجاعة الاقتصادية، بل يمتد ليشمل الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية كالتقليص من البصمة الكربونية وتعزيز التحول الأخضر، وكذلك تطبيق العدالة والإنصاف داخل المؤسسة وخارجها بغية تكافؤ الفرص والتنوع داخل فرق العمل واحترام حقوق العمال وتوفير ظروف عمل لائقة، فضلا عن إشراك الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني في تقييم الأثر الاجتماعي للمشاريع.
وتُعتبر الحكامة الجيدة الركيزة الثالثة في منظومة “ESG”، أي معايير البيئية والمجتمعية والحكامة، وهي تفرض اعتماد قواعد صارمة في ما يخص:
- الشفافية في اتخاذ القرار وتدبير الموارد.
- وضوح الأدوار داخل مجالس الإدارة واللجان المتخصصة.
- تدبير المخاطر وتفعيل آليات التقييم الداخلي.
- التصريح بالمصالح ومنع تضاربها وتعزيز الأخلاقيات المهنية. يرتبط هذا البعد بمجهودات أوسع في إصلاح منظومة الرقابة والتدقيق، ويُعتبر أساسيًا لضمان استدامة الأداء على المدى الطويل.
لكن رغم أهمية مقاربة “البيئة والمجتمع والحكامة”، فإن تنزيلها داخل المؤسسات العمومية بالمغرب لا يزال في مراحله الأولى، ويواجه عدة تحديات، من أبرزها:
- غياب إطار تنظيمي ملزم أو موحّد لتطبيق معايير ” ESG”
- نقص الكفاءات المتخصصة في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وتدبير الحكامة.
- محدودية ثقافة المساءلة المستندة إلى النتائج غير المالية. لذا، يُوصى بوضع إطار مرجعي وطني واضح لتكامل المعايير البيئية والمجتمعية والحكامة، داخل المؤسسات، مع تعزيز القدرات التقنية، وتضمين مؤشرات ESG في نظم التقييم السنوية وخطط العمل.
إن إدماج هذه المعايير في أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لا يُعد خيارًا مؤقتًا، بل يمثل تحولًا بنيويًا في تصور الدولة لدور المرفق العمومي، الذي ينبغي أن يُسهم في بناء اقتصاد أخضر، ومجتمع متماسك، ومؤسسات شفافة. ويُشكّل هذا النهج أداة فاعلة لترسيخ نموذج تنموي جديد، عادل، ومستدام.
دور المؤسسات والمقاولات العمومية في بناء اقتصاد أخضر ومستدام
يرتكز الإصلاح المؤسساتي في المغرب على ثلاث محاور استراتيجية: تحسين ممارسات الحكامة من خلال تأهيل مجالس الإدارة واعتماد تقييم الأداء بالنتائج؛ التحول القانوني بتحويل المؤسسات ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة لرفع التنافسية؛ وأخيراً إدماج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة (ESG) في التدبير، بما يعكس التزاماً بالتنمية المستدامة والعدالة داخل هذه المؤسسات، وذلك تطبيقا للاستراتيجيات القطاعية و المشاريع الضخمة مثل مشروع المبادرة الأطلسية و الطاقات النظيفة والمتجددة التي تحمل من بين أهدافها الحد من الانبعاث الكربوني، وتعزيز النجاعة الطاقية، وتبني ممارسات مسؤولة بيئياً.
رغم هذا التوجه الطموح، لا يزال تطبيق معايير ESG يواجه تحديات، منها غياب إطار تنظيمي موحد، ونقص الكفاءات، وضعف ثقافة التقييم غير المالي. لذا يُوصى بوضع إطار مرجعي وطني وتضمين هذه المعايير في التقييمات السنوية، باعتبارها خطوة نحو نموذج تنموي أكثر عدالة واستدامة
وفي هذا الإطار، برزت مفاهيم جديدة مثل “المالية الكربونية” و“الاستثمار الأخضر” و” الاقتصاد الأخضر و“سلسة التوريد الأخضر“، حيث أضحى من اللازم إدماج مؤشرات البيئة والمجتمع والحكامة في تدبير المؤسسات العمومية، وتفعيل آليات تتبع بصمتها البيئية، عبر تقارير دورية واستراتيجيات للانتقال الطاقي في أفق 2030.
بل لا يقتصر الأمر على البعد البيئي فقط، بل يرتبط أيضاً بمفهوم المرونةالمؤسساتية، أي قدرة المؤسسات على التكيف مع الأزمات البيئية والصحية، وضمان استمرارية المرفق العمومي في سياقات متغيرة. وهو ما يتطلب بناء قدرات داخلية، وتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتعزيز الابتكار في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية.
البعد التكنولوجي: التحول الرقمي في المؤسسات العمومية بين الطموح والواقع
يُعد التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي من أبرز تحديات إصلاح المؤسسات العمومية بالمغرب. فرغم الجهود المبذولة، لا تزال العديد من المؤسسات تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية، وغياب أنظمة معلومات موحدة، ومقاومة ثقافية للإجراءات الرقمية، إلى جانب نقص الكفاءات وبرامج التكوين.
كما يواجه إدماج الذكاء الاصطناعي عقبات تتعلق بغياب استراتيجية وطنية واضحة، وضعف التأطير البشري المتخصص. ولمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر استثماراً في البنية الرقمية، وتأهيلاً للموارد البشرية، وشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، إضافة إلى التزام سياسي ورؤية استراتيجية.
وقد أعلنت الحكومة عن خارطة طريق لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بهدف رفع الصادرات وتحقيق فرص شغل جديدة. كما تم توقيع اتفاقيات لتسريع هذا التحول وتعزيز الابتكار وتغيير العقليات داخل المؤسسات العمومية.
و من ناحية أخرى، شهدت الآونة الماضية توقيع مجموعة من الشراكات و الاتفاقيات بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و بعض المؤسسات العمومية، مما يضاف إلى مخرجات المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي لبعث الأمل فيما يخص إدماج التكنولوجيات الرقمية و الذكاء الاصطناعي في تطوير الكفاءات الرقمية، وتعزيز الابتكار لدى الأطر و المستخدمين داخل المؤسسات الوطنية، خاصة الإسهام في تغيير العقليات.
ضعف ثقافة التدبير بواسطة أنظمة المعلومات المندمجة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية
تُعد أنظمة المعلومات المندمجة من ركائز الإصلاح الإداري الحديث، لما توفره من أدوات فعالة للتخطيط والتتبع واتخاذ القرار المبني على البيانات. غير أن أغلب المؤسسات العمومية في المغرب تعاني من نظم معلومات متقادمة أو مجزأة، وغياب ثقافة مؤسساتية تعتمد التدبير الرقمي الاستراتيجي.
لا يقتصر هذا القصور على البنية التكنولوجية فقط، بل أيضًا بغياب الوعي لدى المسؤولين بأهمية نظم المعلومات كأداة للنجاعة والشفافية، مما يؤدي إلى الاعتماد اليدوي وتعدد مصادر البيانات وغياب مؤشرات موحدة للأداء، ويُضعف التنسيق الداخلي والخارجي.
لذلك، يُصبح من الضروري تبني رؤية رقمية مندمجة تنطلق من أعلى مستويات القرار، مدعومة بالاستثمار في بنى تحتية رقمية وتكوين الأطر، بما يضمن فعالية الإصلاح واستدامة التحول الرقمي.
البعد المتعلق بالموارد البشرية : المحرك لإصلاح المؤسسات العمومية أو الخطر الصامت
تُعد الكفاءات البشرية ركيزة أساسية لاستمرارية وجودة أداء المؤسسات العمومية، إذ تمثل الخبرات المتراكمة لدى الأطر ما يُعرف بـالهوية المؤسساتية (ADN organisationnel) . غير أن غياب إدارة فعالة للمعرفة ( (Knowledge Management يجعل هذه الخبرات عرضة للضياع عند مغادرة الموظفين، مما يؤدي إلى ضعف في نقل التجربة، وتكرار الأخطاء، تراجع الأداء.
تتمثل أبرز المخاطر في فقدان الذاكرة المؤسساتية، وصعوبة استنساخ الممارسات الجيدة، وتعطيل مشاريع الإصلاح. ولتجاوز ذلك، يجب إرساء ثقافة مؤسساتية قائمة على تبادل المعرفة، وتوثيقها، وتدويرها، وتطوير أدوات رقمية لحفظها، مع تعزيز التحفيز وربط الأداء بالمساهمة المعرفية. كما يُوصى بوضع مخططات للتكوين المستمر وتحسين بيئة العمل، إدراكاً بأن الرأسمال البشري يُعد من أهم الأصول اللامادية للمؤسسة.
لذلك، فإن إصلاح المؤسسات العمومية يقتضي ليس فقط تحسين حكامتها أو تطوير إطارها القانوني، بل أيضًا حماية رأس رأسمالها اللامادي من خلال :
- إرساء ثقافة مؤسساتية قائمة على تبادل المعرفة (Knowledge Management).
- اعتماد سياسات فعالة لتوثيق وتدوير المعارف (Knowledge Capture & Transfer).
- ربط تقييم الأداء الفردي بمستوى المساهمة في الإنتاج مع وضع أنظمة واضحة للتقييم و التحفيز (Empowerment).
- تطوير آليات رقمية لحفظ الذاكرة المؤسساتية وإتاحتها للأطر والمصالح المعنية (Gestion de la Data).
- بلورة وبناء شبكة قواعد المعطيات مع البنية التحتية الملائمة (Data warehouse).
- بلورة مخطط متوسط المدى للتكوين المستمر مع وضع المؤشرات و المعايير المناسبة.
- إرساء ثقافة الاعتناء و مراقبة بيئة العمل (Ergonomie).
- وضع خطط شفافة لتدبير المسار المهني للمستخدمين.
ووقوفا عند هذه النقطة، نستحضر قولة هنري فورد، رائد إحدى مدارس التدبير، حول الموارد البشرية “اثنان لا يظهران في حسابات المؤسسة، سمعتها و مواردها البشرية”، الموارد التي أصبحت حاليا توصف بالرأسمال البشري و تدخل كعنصر ضمن الأصول اللامادية للمؤسسة.
إشكالية جودة التمثيلية وتكوين أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية
دائما فيما يخص العنصر البشري، تُعد جودة تمثيلية وتكوين أعضاء مجالس الإدارة عنصراً حاسماً في نجاح إصلاح المؤسسات العمومية. فرغم دور هذه المجالس في تعزيز الحكامة، إلا أن الممارسات الحالية تُظهر اختلالات تتعلق بالكفاءة، والاستقلالية، وهيمنة منطق الانتماء السياسي على معايير التعيين. كما يعاني العديد من الأعضاء من نقص في التكوين المتخصص بمجالات التدبير والحكامة.
لمعالجة هذه الإشكالية، يُوصى بتبني معايير شفافة للتعيين ترتكز على الكفاءة والتخصص، مع تعزيز تمثيلية النساء والمتصرفين المستقلين، وتوفير برامج تكوين مستمر. فتمكين المجالس من أداء أدوارها المهنية بفعالية يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح ورش الإصلاح المؤسساتي.
إن تحسين جودة تمثيلية أعضاء مجالس الإدارة وتكوينهم، يمثل شرطاً حاسمًا لإنجاز مشروع إصلاح المؤسسات العمومية، باعتبار أن هذه المجالس تمثل نقطة محورية في نظام الحكامة الجديد.
البعد المالي و المحاسباتي: نحو حكامة مالية للمؤسسات العمومية
يشكل البعد المالي والمحاسباتي دعامة أساسية لإصلاح المؤسسات العمومية، إذ يُعزز الاستدامة والتوازن عبر تقليص عدد المؤسسات، وتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ورفع مساهمتها في تمويل الدولة. كما يشمل هذا البعد ترشيد الهيكلة المؤسساتية وتوحيد قواعد المحاسبة لزيادة الشفافية وتقوية مصداقية الدولة كمساهم.
وقد عرف المغرب إصلاحاً مالياً عميقاً عبر القانون التنظيمي 130.13، الذي رسخ مبادئ النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال الميزانية المبنية على النتائج، والبرمجة متعددة السنوات. كما تم إدماج المحاسبة التحليلية لقياس كلفة الخدمات بدقة، وتحسين اتخاذ القرار وربط التمويل العمومي بالأداء الفعلي.
بفضل هذه الإصلاحات، يتجه المغرب نحو حكامة مالية أكثر فعالية واستباقية، تواكب التحديات التنموية وتضمن شفافية وجودة الخدمات العمومية.
بفضل هذا التحديث المزدوج للنظام الميزانياتي والمحاسباتي، أصبح المغرب يتوفر على إطار مالي أكثر نجاعة واستباقية، قادر على مواكبة التحديات التنموية، وضمان جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل شفافية أكبر ومسؤولية أوضح.
في الجزء الثاني من المقال، سوف نتناول بعض الحلول العملية التي تم اعتبارها كمفاتيح النجاح لأوارش الإصلاح على صعيد بعض الدول ذات المحيط الإداري و الاقتصادي مماثل للمغرب.
المرجع : هذه المادة منقولة عن الصحيفة : قراءة في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (1/2) – الصحيفة